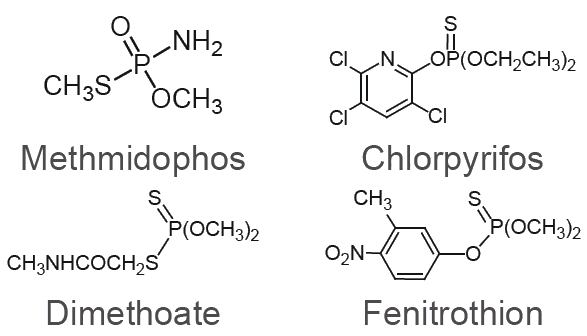المنظومات الزراعية
|
الشكل (1) الأهداف العامة للزراعة
|
الزراعة agriculture هي أنشطة خاصة ذات طبيعة خاصة ينفذها الإنسان، وتميزها معالم وأمور عدة. تُمارس ضمن منظومات زراعية agricultural systems تمتلك جميع المكوِّنات الرئيسة التي يتفاعل بعضها مع بعض، وتُؤلف الوحدات الزراعية التشغيلية، ومخارج زراعية معينة. وبديهي أن المنظومات الزراعية هي في الوقت ذاته منظومات بيئية ecosystems معقدة، ترمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية معظمها - إن لم يكن كلها - مرتبط بمنتجات معينة (الشكل1) وقد تكون المنظومات كبيرة جداً تضم مناطق زراعية واسعة متعددة المحاصيل، أو تكون صغيرة جداً تقتصر على محصول نباتي واحد. كما أن مكوناتها يمكن أن تراوح بين مجموعات من الكائنات إلى قطعان حيوانية كبيرة أو مجموعة من المحاصيل. وتتضمن منتجاتها، نباتات وحيوانات، أو أجزاء منها؛ يُستعمل بعضها غذاءً، وبعضها الآخر ملابس أو مفروشات أو لتوليد الطاقة مثل روث الحيوانات في بعض المجتمعات الفقيرة، أو مأوى. وفي حين تتضمن هذه المجموعة أشجار الفاكهة والمطاط؛ فإن أشجار الغابات غير مشمولة فيها، فتُعامل الحراج والغابات على أنها فرع زراعي خاص.
|
نباتات المحاصيل
|
الثدييـــات
|
الطيـــور
|
عدد الأنواع المستخدمة
|
1000- 2000
|
20 - 30
|
5 - 10
|
% من الأنواع المتوافرة
|
نحو 0.4
|
نحو 0.5-0.75
|
نحو 0.05-0.1
|
عدد الأنواع المهمة اقتصادياً
|
100-200
|
نحو 10
|
4- 5
|
عدد الأنواع التي توفر معظم الإنتاج العالمي من الغذاء
|
15
|
5
|
2
|
|
الجدول (1): عدد الأنواع المستخدمة في الزراعة
|
والزراعة هي علاقات متشابكة وتوازنات دقيقة بين عناصر مختلفة (التربة والنباتات والحيوانات والبيئة والاقتصاد وغيرها). وتكاد الأنشطة الزراعية التقليدية تنحصر بإنتاج الحاصلات المختلفة ورعاية حيوانات المزرعة ودواجنها. ومن ثم يُشير إليها بعض الباحثين بأنها الأنشطة المرتبطة تحديداً باستخدامات التربة الزراعية، ويعدّون الحاصلات والحيوانات التي لا تُُستخدَم التربة في إنتاجها حاصلات غير زراعية بالمعنى الكامل، مثلاً التربية المنزلية للطيور والزراعة المائية[ر]، ولكن هنالك اعتراضات كثيرة على هذا التصنيف.
يتميز بعض الحيوانات والنباتات بسهولة تربيتها والحصول على منتجاتها، ولعلّ هذا أحد الأسباب الرئيسة لقلة عدد الأنواع الحيوانية والنباتية الزراعية المستغَّلة، مقارنة بأعداد الأنواع النباتية والحيوانية المنتشرة في العالم (الجدول 1).
ويبين الجدولان (2) و (3) الحيوانات والنباتات المهمة زراعياً في معظم أنحاء العالم.
المنتجات النباتية كثيرة، ويُستعمل كثير منها في تغذية الإنسان مثل الخبز من القمح وأنواع نجيلية أخرى، والسكر والأرز والخضار المختلفة وأنواع كثيرة من الفاكهة والبذور والزيوت، وفي إعداد منتجات صناعية مثل التبغ والعطور والأدوية والأصبغة والمشروبات، وغيرها. أما المنتجات الحيوانية فهي أقل عدداً، وفي مقدمتها الحليب واللحوم والبيض والأسماك والعسل، يُضاف إليها منتجات أخرى مثل الصوف والفراء والحرير والجلود والقرون والأظلاف والريش ومسحوق العظام والدم المجفف والروث.
الثدييات
|
الأبقار
الجاموس
الأغنام والماعز
الخيول والحمير والبغال
الخنزير
الإبل
|
الطيور
|
الدجاج المستأنس
البط والإوز
الحبش
|
فقاريات ذات دم بارد
|
الأسماك
|
لافقاريات
|
النحل
دود القز
|
الجدول (2): الحيوانات الزراعية الرئيسية
|
يُستخدم مصطلح «العلوم الزراعية» أحياناً لوصف الدراسات والأعمال الزراعية، ولكن ذلك قد يكون مُضللاً في بعض الأحيان، وذلك لأن الزراعة تضم في الواقع علوماً مهمة أخرى، ومن ثم قد يكون من الصعب فصلها عنها. ومن ثم يجب الاهتمام بجميع هذه الموضوعات معاً؛ وفي مقدمتها العلوم الاجتماعية والاقتصادية والحيوية (البيولوجية) والهندسية والبيطرية والغذائية والوقائية وغيرها من علوم ومعارف ذات صلة وثيقة بالزراعة و تدعم وظائفها وعملياتها (الشكل 2).
وانطلاقاً مما سبق، فإنه يمكن القول: إن الزراعة هي أنشطة إنسانية عديدة وهادفة، تُستغل علومها في إنتاج الغذاء واللباس وكذلك الطاقة ومنتجات أخرى، عبر استخدامٍ منَظَّمٍ للنباتات والحيوانات المهمة، يُحقِق أيضاً موارد مالية مناسبة للقائمين بها، ومن ثم فإنها في الوقت ذاته، نشاط اقتصادي بالغ الأهمية.
هنالك نماذج متعددة من المنظومات الزراعية، منها على سبيل المثال نموذج عام لمنظومة مجترات في بريطانية مبين في الشكل (3).
إذن فالزراعة: تداخلات وتفاعلات وتوازنات بالغة التعقيد تضم عوامل كثيرة، وتهدف إلى تحقيق أمور كثيرة، وإن كثيراً من الزراعات الحديثة قد فقد التوازنات اللازمة لتحقيق الاستدامة البعيدة المدى، كما أن الاعتماد المكثف على المحروقات غير المتجددة والمُدخلات الخارجية قد سبّب إساءة استخدام التربة وتدهورها، وهذا ما حدث أيضاً للمياه والأنماط الوراثية والموارد الثقافية التي اعتمدت الزراعة دوماً عليها. وإن استمرار الاعتداء على ما يجب أن يُترك للأجيال القادمة، سواء من المياه أم المحروقات أم التربة أم الموارد الوراثية الأساسية أم غيرها؛ سيترك آثاراً سلبية على الزراعة والمزارعين والمستهلكين. وإن العودة إلى تنفيذ منظومات زراعية حكيمة تضمن استدامة الزراعة أمر بالغ الأهمية.
لهذا يرغب المخططون والباحثون في تنفيذ منظومات زراعية مستدامة[ر] sustainable agriculture، تشتمل على مشروعات زراعية متكاملة من الإنتاجين النباتي والحيواني، يُعتمد فيها على استخدام جميع العلوم الفيزيائية والكيمياوية والحيوية (البيولوجية) والاقتصادية بغية تفهم المشكلات الزراعية وحلها، وذلك بغية تحقيق الأهداف الآتية:
ـ توفير احتياجات الإنسان من الأغذية والألياف.
ـ تحسين البيئة المحلية وقاعدة الموارد الطبيعية اللتين تؤثران في الاقتصاد.
ـ الاستخدام الأمثل للموارد غير المتجددة وموارد المزارع المحلية.
ـ استمرارية الحيوية الاقتصادية economic viability للإدارة المزرعية.
ـ تحسين نوعية الحياة للمزارعين وأفراد المجتمع عامة.
النجيليات
|
القمح، الشعير، الأذرة، الأرز، الشوفان، الميليت.
|
القرنيات
|
الفول، البازلاء، فستق العبيد، فول الصويا.
|
الحاصلات العلفية
|
الفصفصة، البرسيم، البيقية، الكرسنة، الحشائش والأعشاب.
|
الحاصلات الزيتية
|
الزيتون، النخيل، فستق العبيد، بذر القطن، بذر عباد الشمس، بذر فول الصويا.
|
المكسرات
|
اللوز، الجوز، البيكان، الفستق الحلبي.
|
الحاصلات السكرية
|
الشمندر السكري، قصب السكر
|
الحاصلات الدرنية والجذرية
|
البطاطا، البطاطا الحلوة، الكاسافا، الفجل، البصل، الثوم، اللفت.
|
الحاصلات الورقية
|
السبانخ، الملوخية، الملفوف، الخس، التبغ.
|
الثمار
|
التفاح، الكمثرى، الخوخ، الدراق، الحمضيات (الموالح)، العنب، الكرز، الفريز.
|
المنبهات والتوابل
|
الشاي، البن، الكاكاو، الفلفل، القرفة.
|
الأزهار
|
الياسمين، الورد، الفل، الزنبق.
|
النباتات الطبية
|
اليانسون، الصعتر، الخطمية، الكركدية، الكينا، الخشخاش.
|
محاصيل الألياف
|
القطن، الكتان، الجوت.
|
|
الجدول (3): نماذج من الحاصلات النباتية الزراعية الرئيسية
|
ويتطلب ذلك أيضاً التركيز على البنى التحتيةinfrastructures التي تتضمن دعماً متكاملاً للنماذج modelsالمختلفة، وقواعد البياناتdatabases والبرامج وبروتوكولات التوثيق واستراتيجيات معالجة البيانات، والتركيز على الدراسات الحقلية وغير الحقلية المساندة لها. كما أنها ستحتوي على أجزاء بحثية وأخرى تنمويةdevelopmental. ومن الضروري اشتراك جميع المهتمين بها في تخطيطها وتنفيذها لأن ذلك سيضمن استدامة الحلول من الوجهتين البيئية والاقتصادية، وتطوير حلول جيدة للمشكلات المدروسة. ولابد في هذا المجال من الاستعانة بمدخلات ونواتج مهمة، منها مايأتي:
1 ـ توافر المعرفة العلمية الخاصة بالمنظومات الزراعية، ويشمل ذلك تعريف المنظومة الزراعية وكيفية دراستها؛ وكيفية تعريف مكوناتها المهمة وطرائق دراسة مكوناتها كافة، مثل التآثرات (التفاعلات) interactions بين المكونات الحيوية والفيزيائية والكيمياوية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
2 ـ دمج معلومات جميع البرامج المدروسة وبياناتها ضمن «رزم» packages يُمكِن لغالبية العاملين في حقولها تنفيذها بسهولة وكفاءة.
3 ـ تحقيق إمكانات استعادة قواعد البيانات والمعلومات والأدوات التحليلية لشؤون إدارة المزارع، والقدرة على استخدام البيانات المتحصل عليها من برامج أخرى استخداماً جيداً، مثل نماذج المياه والمخصبات والمبيدات والإنتاج المزرعي.
4 ـ تقانات تُحسِّن حيوية المنظومات الزراعية المختلفة (النباتية والحيوانية) أو تُمكِّن من تطوير منظومات إنتاجية مستدامة أخرى.
5 ـ استخدامات تركيبية لجميع العاملين في الزراعة، مثل المنتجين ومقدمي الخدمات والمدخلات، والمرشدين الزراعيين والعاملين في التعليم الزراعي وما يرتبط بهم من علوم، وغيرهم، وذلك للاستفادة منهم في تحديد المشكلات البحثية والتنموية وأولوياتها.
6 ـ تحقيق برامج متكاملة ذات قواعد علمية بغية تحديد الموضوعات والمشكلات الزراعية في المنطقة المعنية؛ وتقويم مدى أهميتها بالنسبة إلى الإنتاجية والبيئة والاقتصاد وعوامل أخرى عدة تهم المجتمع الريفي والزراعي الذي تُدرس فيه.
كانت المشروعات الزراعية في أثناء القرن العشرين تهتم بمفاهيم محددة مثل: توفير العمل الزراعي، التسويق، التمويل، الموارد الطبيعية، الموارد الوراثية، التغذية، الأدوات والآليات، الأخطار الممكنة، وغيرها. ومع أنه من الممكن معالجة كل من هذه المفاهيم وغيرها على نحو جيد، إلا أن النتائج تكون أفضل بمعالجة عدد منها معاً، قلّ أو كثر، على أساس منظومة زراعيةagricultural system متآثرة (متفاعلة) ومتكاملة، حيث يكون تأثير التآثر بين مكونات متعددة أكثر أهمية من تأثير كل منها وحده. وإن معالجة العمليات الزراعية كمجموعة توفر مرونة إدارية أفضل، كما توفر ظروفًا أكثر سلامة للعاملين في الزراعة وللحيوانات الزراعية.
|
الشكل (2) التداخل بين الزراعة وعلوم وأنشطة أخرى (اقتصر للتبسيط على ثلاثة منها)
|
بلغ إنتاج كثير من المحاصيل في بلدان عديدة ـ ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ـ حداً كبيراً، ومن ثم أدى ذلك إلى حدوث فائض كبير في المنتجات، مما دعا كثيراً من المزارعين إلى التوقف عن استغلال قسم من أراضيهم. وقد أدت الزيادات الإنتاجية الكبيرة إلى انخفاض كبير بمساحات عدد من الحاصلات الزراعية ؛ في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج، وأدى ذلك إلى انخفاض دخل المزارعين، ومن ثم إلى توقف عدد كبير منهم عن العمل في الزراعة، وأُجبر كبار المزارعين على السعي إلى زيادة كفاءة إنتاجهم الزراعي عبر تقليص التكاليف وتعظيم maximization الإنتاج. وفي الوقت ذاته، ازداد اهتمام الناس بذلك وازداد الضغط الذي يمارسونه على المزارعين لتحقيق بيئة أفضل ومنتجات أكثر سلامة، عبر السعي نحو الحفاظ على نظافة الهواء والماء والتربة؛ وحسن معاملة الحيوانات، وإنقاص استخدام المبيدات والكيمياويات كثيراً، وغيرها.
وصار الاهتمام بالاستدامة الزراعية أمراً أساسياً ومركزياً لمعظم البرامج الزراعية، وفي حين يمكن المحافظة على استدامة اقتصادية لنشاط زراعي ما بوساطة وسائل صنعية، فإن هذا الاتجاه قد لا يبقى مستداماً على المدى البعيد، ومن ثم فإن التكاليف والتنظيمات البيئية وتغيرات السوق ستجعل الدعم الصنعي غير ممكن، ومن جهة أخرى فإن النشاط الزراعي المصمَّم ليكون مستداماً من الناحية البيئية يمكن أن يكون أيضًا مستداماً اقتصادياً بوساطة الضغوط التنظيمية والتسويقية واستخدام التقانات الحديثة والسواتل الصناعية وغيرها. وإن هذه الآليات تُشجع كثيراً أنشطة البحوث والتعليم والإرشاد لبرامج المنظومات الزراعية التي يُشار إلى بعض الأمثلة منها فيما يأتي:
- الزراعة العضوية: الزراعة العضوية organic agriculture هي منظومة إنتاجية تتحاشى، أو تستبعد ما أمكن استخدام المخصبات المصنَّعَة والمبيدات والإضافات additives الغذائية للحيوانات والدواجن ومنظمات النمو (التي انتشر استخدامها بصورة مرعبة وبالغة الخطورة والضرر في البلدان النامية حيث يُسميها كثيرون بالهرمونات). وتعتمد هذه المنظومة على أقصى استخدام ممكن للدورات الزراعية crop rotationsالحكيمة، وبقايا النباتات وروث الحيوان (السماد العضوي أو البلدي) والبقولياتlegumes والسماد الأخضر green manure والمنتجات العضوية غير الزراعية والحصاد الآلي والمكافحتين الحيوية والمتكاملة للحشرات والطفيليات.
إحدى المميزات المهمة للزراعة العضوية هي استخدامها الأقل لطاقة الدعم support energy الناتجة من مصادر غير الإشعاع الشمسي solar radiation الراهن. ومن المعلوم أن الفحم والغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته هي مصادر غير متجددة، احتاجت لتكونها إلى آلاف السنين، وهذه المدة الزمنية هي التي تهم الناظر إلى الاستهلاك غير الحكيم لهذه المنتجات. إن الطاقة الشمسية التي ثُبِتت في أشجار بالغة قد احتاجت إلى مدة طويلة لتثبيتها، وإن رجلاً عمره خمسون عاماً يحرق قطعاً من أشجار بلوط oaks ينهي طاقة لن تتجدد فيما بقي له من العمر. المشكلة الأساسية هي الاستهلاك غير الحكيم الذي يجعلها إلى زوال قريب. ومع أن هنالك موارد مهمة أخرى يمكن استخدامها مصادر للطاقة (الرياح والأمواج والطاقة النووية)، لكن تقنيات استخدام بعضها لم تصل بعد إلى الكمال والسلامة المطلوبين.
لعل المزيّة الكبرى للزراعة هي قدرتها على استغلال الإشعاع الشمسي في إنتاج الغذاء والألياف لمنفعة الإنسان، في الوقت الذي لا تتمكن أي صناعة أخرى من ذلك إلى أي حد جدير بالاهتمام. إذن فالزراعة: هي «النفط» الذي لا ينضب مادامت أشعة الشمس مستمرة بإضاءة الأرض.
أصبحت الزراعة العضوية إحدى الركائز المهمة والمتنامية في كثير من البلدان، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، مثلاً، تضاعفت هذه الزراعة وازداد استهلاك منتجاتها بنسبة 20% في العام في أثناء السنوات العشر الأخيرة. وإن نحو 80% من المنتجات الزراعية العضوية المباعة اليوم هي من الفواكه والخضراوات الطازجة. وقد ازدادت أهمية هذه الزراعة بصدور تنظيمات تتعلق بمعاييرها، سنّتها وزارة الزراعة الأمريكية عام 2002، وتبع ذلك تشريعات مهمة من بعض الولايات هدفت إلى طمأنة المستهلكين إلى أن ما يتناولونه هو فعلاً منتجات زراعية عضوية.
يعود تاريخ الزراعة العضوية الأمريكية إلى سنوات حدوث ما سُمي كرة الغبار dust bowl في الثلاثينيات من القرن العشرين، حيث كانت عمليات الحراثة كثيفة جداً وأدت إلى إتلاف بنية التربة وتركيبها في مناطق كثيرة، ولاسيما المواد العضوية الموجودة فيها، مما زاد حجم هذه المشكلة. ونبَّه إدوارد هـ. فولكنر Edward H. Faulkner على ضرورة الحفاظ على التربة ومكوناتها الطبيعية باستخدام طرائق حديثة للحراثة، واستخدام أقل حدّ ممكن من عمليات تغيير معالم التربة. وتبعه عدد كبير من الباحثين الذين ركَّزوا على هذه الأمور على نحو جاد ومستمر.
- معالجة السماد العضوي والموارد الغذائية: السماد العضوي (البلدي) manure هو مصدر مهم لتغذية النبات، ويمكن أن يصير مصدراً مهماً للتلوث البيئي، ومن ثم فإن المعالجة الجيدة للعناصر الغذائية nutrients التي يحصل عليها من المخصبات (الأسمدة) المختلفة الطبيعية أو الصنعية ومخلفات النباتات أمر بالغ الأهمية بشأن الحفاظ على البيئة وتوفير الإمكانات الجيدة للمشروعات الزراعية المختلفة، الحيوانية أو النباتية. ولهذا فإن كثيراً من الهيئات البحثية والإرشادية والتعليمية والجمعيات الزراعية تتعاون لتوفير أفضل المعلومات والوسائل التطبيقية للإدارة الحكيمة لمصادر السماد على اختلاف أنواعه والعناصر الغذائية النباتية واستخداماتها.
يزيد من خطورة هذه الأمور أن المنتجات الحيوانية تُعدّ عاملاً ملوثاً للمياه السطحية وضاراً بها (بسبب العناصر الممرضةpathogens والفسفور والأمونيا والمادة العضوية)، وللمياه الجوفية (من النترات)، ولنوع التربة (من الأملاح الذائبة فيها والنحاس والزرنيخ والزنك)، ولنوعية الهواء (من الروائح الكريهة والغبار والطفيليات والعناصر الممرضة).
وإضافة إلى أضرار المواد العضوية والمعدنية فإن مخلفات النباتات والسماد الأخضر قد تضر بالبيئة عبر زيادة العناصر في المواقع التي تُضاف فيها، كما أنها تضر المياه، ويمكن أن تظهر آثارها الضارة والمتراكمة في مناطق بعيدة جداً عن أماكن إضافتها، ويُعتقد أن الاستخدام المكثف للمخصبات الآزوتية (النتروجينية) في حوضي نهر الميسيسيبي في ولايتي ميزوري وميسيسيبي الأمريكيتين هو السبب الرئيس لمشكلات نقص التأكسج hypoxia في خليج المكسيك. وقد تتراكم العناصر المعدنية بشكل أملاح salts مثل السلفيدات والسلفات وأملاح البورون والسيلينيوم والمعادن الثقيلة.
ولهذا يتم في كثير من البلدان تنظيم برامج بحثية وتعليمية وإرشادية متكاملة لدراسة هذه الآثار الضارة ومنع حدوثها، والتي يمكن أن تتعدى التربة والماء والهواء والنبات والحيوان لتصيب الإنسان نفسه. ويُستفاد من هذه الدراسات في تنظيم برامج زراعية دقيقة تتضمن جميع العناصر المؤثرة في شؤون استخدام السماد العضوي والمعدني وتحديد الآثار المترتبة عنها في المجتمعات الزراعية والمجتمعات الاستهلاكية وارتباطات ذلك باقتصاديات الإنتاج الزراعي.
- منظومات إنتاج المجترات في مناطق جنوبي الصحراء Sub-Saharan الإفريقية: يمكن تصنيف إنتاج المجترات وفقاً لعدة معايير، من أهمها تكامله مع إنتاج المحاصيل، والعلاقة بين الحيوان والأرض، ومدى كثافة الإنتاج ونوعيته. كما أن هنالك معايير أخرى مثل حجم الحيازات الحيوانية وقيمتها الاقتصادية، حركة الحيوانات والمسافات التي تقطعها ومدها، العروق breedsوالنماذج types المربَّاة، العلاقة بين مشروعات الحيوانات والسوق، والظروف الاقتصادية السائدة، وغيرها.
صَنَّف سيريه وشتاينفِلد Seré and Steinfeld منظومات الإنتاج الحيواني العالمي في أربعة نماذج رئيسة هي الآتية:
1 ـ المنظومات المؤسسة على المراعي grassland-based systems، وهي تعتمد أساساً على الحيوانات، وفيها يأتي أكثر من 90% من المادة الجافة dry matter المغذَّاة للحيوانات من المراعي الواسعة أو نباتات الأعلاف المزروعة حقلياً أو منزلياً، وتقل معدلات الحيازة السنوية عن 10 وحدات حيوانية livestock units بالهكتار من الأراضي الزراعية.
2 ـ المنظومات المطرية المختلطة rainfed mixed systems، وفيها يُحصل على أكثر من 10% من المادة الجافة المغذاة للحيوان من مخلّفات by-products المحاصيل، أو أكثر من 10% من القيمة الكلية للمنتجات من أنشطة زراعية غير حيوانية. وفي هذه المنظومات تقدم الزراعة المطرية أكثر من 90% من قيمة المنتجات الزراعية غير الحيوانية.
3 ـ المنظومات المروية المختلطة irrigated mixed systems، وهي مماثلة للمنظومة السابقة، إلا أنها تتميز بأن أكثر من 10% من قيمة المنتجات غير الحيوانية تقدمها الزراعة المروية.
4 ـ منظومات الإنتاج الحيواني من دون أراضٍ landless livestock production systems، وهي نظم إنتاج حيواني فحسب، حيث يكون مصدر نحو 10% أو أقل من المادة الجافة التي تتغذى بها الحيوانات من إنتاج مزرعي، وحيث تزيد معدلات الحيازة السنوية على 10 وحدات حيوانية بالهكتار.
القسم الثالث من هذه المنظومات غير مهم نسبياً في المناطق الواقعة أسفل الصحراء الإفريقية، وقد بدأ عدد قليل منها في التكون في بعض المناطق، مثل غينيا- بيساو Guinea-Bissau والمنطقة الوسطى من تنزانيا Tanzania.
يمكن استخدام إحدى دراسات منظمة الأغذية والزراعة FAO نموذجاً لدراسات منظومات الأبقار والمجترات الصغيرة (أغنام وماعز) في مناطق جنوبي الصحراء الإفريقية، والتي تتصف بكونها إحدى المناطق ذات المجموعات الإنسانية الفقيرة والسريعة التكاثر، بمعدل سنوي قدره 2.6%، وفي هذه الأحوال لا يحصل الفرد سوى على النزر اليسير من المنتجات الحيوانية (نحو 11كغ لحوم و27.2كغ حليب) مقارنة بمتوسط الدول النامية منها (26.4كغ لحوم و48.6كغ حليب). يُضاف إلى ذلك انخفاض إنتاجية المجترات في جميع المنظومات الزراعية فيها بسبب رداءة الأنماط الوراثية للمجترات وسوء الشروط البيئية التي تحيط بها.
هدفت هذه الدراسة أساساً إلى تكوين قواعد بيانات databases عن الإنتاج الحيواني في هذه المناطق الإفريقية عبر جمع البيانات الكمية حول شؤون منظومات إنتاج المجترات ومراجعتها وتحليلها، وركَّزت على الأبقار والأغنام والماعز لأنها الأكثر انتشاراً في تلك المناطق، فهي تؤلف نحو 88% من الوحدات الحيوانية المدارية (tropical livestock units (TLUs، وهي نسبة لايُتوقع تغيّرها في المدى المنظور.
الانطلاق الرئيس لهذه الدراسة هو أن المجترات في تلك المناطق تُربّى ضمن منظومات زراعية مختلفة، لكل منها ظروف خاصة، وطاقات إنتاجية ومساهمات متباينة في الإنتاج الكلي. وقد صُنفت منظومات إنتاج المجترات فيها في فئتين رئيستين:
- فئة تقليدية traditional (رعوية pastoral، ورعوية زراعية agropastoral وخليطة mixed).
- فئة غير تقليدية non-traditional (مزارع واسعة ranches وإنتاج حليب).
وقد استخدمت أربعة معايير (زراعات مطرية rainfall، وطول موسم النمو، والنموذج الزراعي، ومتوسطات درجات الحرارة في أثناء موسم النمو) بغية تقسيم النظم الخليطة إلى تحت مجموعات، ورُبّيت الأبقار والأغنام والماعز في جميع النظم. وعلى هذا فإن البيانات التي نتجت وفَّرت وصفاً جيداً للمنظومات المدروسة بما يخص تراكيبها وأحجام قطعانها وإدارتها ووظائفها وإنتاجياتها وظروفها البيئية، وغيرها من عوامل يمكن الاستفادة منها في رسم خطط تحسينها.
المنظومات الحيوية في الزراعة
ثمة منظومات حيوية (بيولوجية) biological systems ضمن الزراعة، ويمكن النظر إلى كل حيوان وكل محصول منظومة مستقلة، ومدُّ ذلك إلى أجزاء جسم الحيوان (مثل الكرش في بقرة) أو الحشرات التي تصيب نباتات محصول ما أو الطفيليات التي تصيب الحيوانات.
ترتكز أهمية هذه المكونات بالنسبة إلى الزراعة على أدوارها ضمن المنظومات الزراعية، وليس لها أهمية خاصة حينما تُدرس منعزلة عن ارتباطاتها بهذه المنظومات، ولن يكون لها في هذه الحال أهمية تذكر في أعمال التحسين الزراعي. وعلى هذا فلكي يكون للمنظومات الحيوية أهمية زراعية، فإنه يجب أن تمثل «تحت منظومات» sub-systems من المنظومات الزراعية الكاملة، إذ يمكن النظر إلى الزراعة من مفهوم حيوي؛ فتحتوي هذه النظرة العامة على نباتات وحيوانات نامية، يجب أن ينتج كل منها منتجات (وتحت منتجات) وكذلك منتجات أخرى غير صالحة للاستعمال (يمكن أن يُعاد تصنيع بعضها)، وأن تكون قادرة على التكاثر لإنتاج الجيل التالي. وفي هذه المنظومات تؤدي العناصر الغذائية والماء أدواراً مهمة كمدخلات inputs رئيسة (الشكل 4)، إضافة إلى عدد آخر من العوامل البيئية المحيطة بالمنظومات الزراعية والحيوية.
ختاماً، ينبغي أن ترمي المنظومات الزراعية إلى دعم استقرار التوازن البيئي في الغابات واستدامة مكوناته ومكوناتها، والتوقف عن اقتطاع ملايين الهكتارات منها في كثير من القارات كما هو حادث في إفريقيا والبرازيل وغيرهما، والسعي إدارياً وفنياً إلى حفظ الموارد الطبيعية المختلفة وتوازن منظوماتها المستدامة بين الأراضي المخصصة للغابات والمراعي والزراعةagro- sylvopastoral equilibrium، لتتحقق الاستفادة منها اقتصادياً وبيئياً وصحياً وجمالياً.